قراءة في طروحات محمد مراد حول النخب والسلطة في المشرق العربي
قراءة وتحليل ؛ د. إسماعيل نوري الربيعي
العراق المعاصر
سعت سلطات الانتداب البريطاني إلى تكريس حضورها على العراق، من خلال تعميق أثر الانفصال على الصعيد الاجتماعي، حتى أنها لم تتردد من توسيع الهوة بين الريف والمدينة، من خلال الإصرار على تغذية معالم النظام القبلي على حساب العلاقات المدنية ولم تغفل المس بيل من التعبير عن محاباتها وتفضيلها لرجال العشائر على حساب رجال المدن، والتي كانت ترى فيهم مجرد مشاغبين ومتطفلين. والواقع أن نظام المشيخة القبلي والذي تم التهليل له من قبل البريطانيين، كان ينطوي على المزيد من الغايات والأهداف، لعل الأبرز منها محاولة السيطرة على الجانب الأمني، باعتبار شيوخ القبائل الممثلين الرسميين لقبائلهم، فيما برز العامل الاقتصادي بقوة من خلال العمل على توزيع الأراضي الزراعية الواسعة لصالح الشيوخ والأغوات الأكراد، مما كان له الأثر الأبرز في تحول العلاقات القبلية الأبوية القديمة والمستندة إلى رابطة الدم والقرابة، إلى مجرد علاقة تحكمها المصالح الإقطاعية. وإذا كانت ملامح هذا النظام تعود أصوله التاريخية إلى قانون الأراضي العثمانية عام 1858، والقاضي بتوسيع مجال نظام الطابو والسعي نحو تحويل الملكيات المشاعية إلى أملاك خاصة، وجعل الفلاحين مجرد مؤجرين لصالح الشيوخ، فإن العلاقة بقيت تدور في فلك رابطة القرابة، هذا على الرغم من بروز حالة دخول الإنتاج الزراعي في العراق في مرحلة الإنتاج الرأسمالي في أعقاب افتتاح قناة السويس عام 1869، وزيادة الطلب العالمي على الحبوب العراقية، وظهور المزيد من القرى والمدن التجارية والتي تم إنشاءها في سبيل تلبية حاجة التجار لتجميع الناتج الزراعي،. إلا أن التحول الأخطر كان قد تبدى في سلسلة الإجراءات البريطانية والتي عملت على تحويل هذا النظام بمثابة الوسيلة التي يتم من خلالها مكافئة المتحالفين معها.
سارع البريطانيون إلى جني فوائد العلاقة مع السلطة العشائرية، من خلال ترصين مواقعهم في البرلمان العراقي، حتى وصل منهم أربعة وثلاثون عضوا من أصل تسعة وتسعين. ومن هذا نجد الزعماء العشائريين وقد أرادوا رد الجميل، عبر إطلاق المزيد من التعهدات في تأييد المعاهدة العراقية البريطانية، وتكريس الدستور العراقي بما يتوافق والمصالح البريطانية بالإضافة إلى الإبقاء على نظام الأراضي الذي أقرته السلطات الانتدابية. ومن هذا برزت حالة التكريس لنفوذ الملاك التقليديين من بكوات ومشايخ وآغوات، والذين راح نفوذهم يتسلل في صلب الحكومة العراقية الناشئة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل استطاع السراة والمتنفذون من أصحاب المصالح التجارية الكبرى والملكيات الواسعة من الاحتفاظ بمكانتهم والتي جاءت عبر التحالف المعلن مع السلطة الانتدابية.
سياسة الأرض
كانت القوانين العقارية تسير إلى صالح كبار الملاك، حتى أن قانون اللزمة الصادر عام 1932، وقانون التسوية عام 1938 أفاد كبار الملاكين من المشايخ والأغوات، من خلال نقل الأراضي المشاعية لصالحهم. وراحت الملكيات الواسعة للأراضي تتوسع بشكل ملفت، حتى أن العام 1930 قد شهد في بغداد لوحدها تسجيل 360 ملكية واسعة تبلغ مساحة الواحدة منها ما يقارب مليون وأربعمائة وأربعون ألف متر مربع. أما في أربيل فقد كان اثنان من الأغوات يملكون خمسة وأربعين قرية. وحتى العام 1958، راحت الملكيات الفردية تتوسع بشكل ملفت، حتى طفت على السطح ظاهرة الملكية الفردية للأراضي على حساب النسبة الكبيرة من العراقيين الذين لا يملكون شيئا. وقد تكرست هذه الظاهرة في مناطق جنوب العراق فأراضي العمارة سيطر عليها حوالي 17 شيخا وأغلب أراض الكوت سيطر عليها الشيخ محمد الحبيب، أما أراضي المنتفق فقد تمكن الشيخ موحان الخير الله من السيطرة على حوالي مليون دونم عام 1949 بعد عقد أواصر التفاهم مع الشخصية النافذة السيد عبد المهدي.
منذ بواكير العهد الملكي حاول ملاك الأراضي توكيد حضورهم في جسم الدولة، حتى أنهم لم يتوانوا من الاعتراض على تعيين بعض الضباط الشريفيين في المناصب السياسية العليا، لاعتبارات تتعلق بالأصل والعرق، ومدى التأثير الاقتصادي. وفي الوقت الذي اتجه أغلب المشايخ نحو توسيع أملاكهم ومراقبة الفلاحين وفرض السيطرة عليهم، جاء قانون حقوق وواجبات الزراع عام 1933، ليجعل من الفلاحين بمثابة الرقيق المرتبطين بالأرض، تحت مبرر أن الفلاح لا يمكنه الخروج من الأرض ما لم يحصل على ورقة من الملاك تؤيد براءة ذمته من الديون. وفي خضم المناورات والتقرب من السلطة العليا، والتنافس المحموم بين المشايخ، باتت المواقف من الأحداث الكبرى تكشف عن مستقبل كل ملاك، فقد حاول العديد منهم الإفلات من تحديد موقفهم من ثورة عام 1920، وتزاحموا من أجل الموافقة على إتمام معاهدة 1930 مع بريطانيا، وتغاضوا عن حركة الضباط القوميين عام 1941، حتى أنهم حصلوا على المزيد من الامتيازات والتي تمثلت في توسيع حيازة الأراضي، ووقفوا بالضد من انتفاضة الشعب عام 1948 الرافضة لمعاهدة بورتسموث.
بقي الطابع العشائري يمثل الواجهة في الحراك السياسي. وصولا إلى منتصف الثلاثينات، حيث تبلورت ملامح دور المدينة السياسي من خلال ظهور جماعة الأهالي وتنامي التيار القومي، وبروز الدور المديني الواضح في وثبة 1948 وانتفاضة 1952. وكان للإقطاعيين الدور البالغ في ظهور الهجرة من الريف إلى المدينة، هذه الهجرة التي تزامنت مع صدور قانون 28 عام 1933، فقد تعرض الفلاحون للمزيد من الضغوط إن كان على صعيد خراب التربة والفيضانات المتكررة والمطالب المبالغ بها من قبل الملاك، فكان الهرب إلى المدن بمثابة الحل السحري للفلاحين، حتى أن إحصاء العام 1957 كان يشير إلى أن نسبة المهاجرين من الفلاحين في بغداد قد بلغت 29% فيما بلغت في البصرة 18%. وكانت بغداد قد استقبلت خلال السنوات 1947- 1957 ما يقارب الربع مليون نسمة، جلهم كان مهاجرا من الجنوب. هؤلاء الذين عانوا من حياة الشظف والعوز، والذين سكنوا في مناطق الهامش حيث مناطق الصرف الصحي، وعاشوا في أكواخ بدائية يطلق عليها الصرائف. ومن واقع انعدام المهارة لم يجد مهاجرو الجنوب سوى العمل في الجيش والشرطة، أو المهن التي لا تحتاج إلى مهارة.
الأحزاب والنخبة الحاكمة
اتجه أصحاب المصالح بكل ثقلهم نحو توطيد نفوذهم من خلال محاولة السيطرة على الحياة السياسية، ومن هذا كان التطلع نحو ترسيخ مظهر التكتلات العائلية والقرابية وإقحامها في صلب العملية السياسية. وكان السعي الدائب نحو الحصول على المقعد البرلماني، الذي لا يتوقف أمره عند الجاه والهيبة، بل يكون له دوره الفاعل في توجيه وتحديد المزيد من المصالح، وبهكذا خلفية تم تأسيس الحزب الحر العراقي عام 1922، والذي ضمت هيئته التأسيسية مجموعة من كبار الملاك، ليعمد باقي الملاك للانضواء تحت زعامة الحزب، والذي تكرست أهدافه على تأييد البريطانيين، ولم يتردد كبار الملاكين من الإعلان عن انخراط عشيرتهم بالحزب، باعتبار علاقة الدم التي تربط الملاك بفلاحيه. ولم يغب الملاكون عن الانضواء في الحزب الوطني العراقي، الذي تأسس عام 1922، ولكن بنسبة أقل. أما حزب التقدم الذي أسسه عبد المحسن السعدون عام 1925، فكان تمثيلا واضحا للتكتل البرلماني الذي يمثله كبار الملاك. وكان حزب الاتحاد الدستوري الذي تأسس على يد نوري السعيد، قد أفرز نوعا خاصا من التحالف بين الملاك وأصحاب النفوذ، في سبيل احتكار السلطة من خلال التمثيل البرلماني. وبسعي واضح من قبل الوصي عبد الإله ونوري السعيد، تم العمل على ترييف البرلمان العراقي، حتى أن النسب تكشف عن حالة من التنامي، خلال الدورات البرلمانية المتعاقبة، فقد بلغت نسبة الملاكين في برلمان 1943 حوالي 31%، وعام 1948 حوالي 34% وعام 1954 حوالي 37% وعام 1958 حوالي 35%.
النشاط التجاري
حتى ثلاثينات القرن العشرين، بقيت النظرة الاجتماعية تقوم على الأصل، لكن طبيعة الحراك التجاري وما نجم عنه من تراكم الثروات لدى البعض من الفئات، جعل أثرياء المدن يتساهلون في مسألة العرق والنسب في تكوين علاقات النسب، باعتبار البحث عن المنزلة الاجتماعية. لكن التوزيع التجاري في العراق كان ركز نشاط التجار المسلمين على الصعيد الداخلي، أما التجارة الخارجية، فقد كان نصيب التجار اليهود مع انكلترا، فيما تركزت العلاقة مع فرنسا بالنسبة للتجار المسيحيين. وكانت أبرز العوائل التجارية العاملة قد تمثلت في ؛ الغنام والقصاب وشوكت، والملوكي وكبة والنجدي، والشهبندر والزيبق والجرجفجي، فيما برز من العوائل اليهودية؛ ساسون وزلخة وحزقيال وقدوري. ومن واقع الاحتلال البريطاني للعراق، فإن السلطات الإحتلالية وجهت عنايتها لرعاية التجار اليهود، حتى أنهم في ثلاثينات القرن العشرين صاروا يمثلون القوة المالية والتجارية في البلاد، بل أن عدد الصرافين من اليهود كان قد بلغ في العام 1936 حوالي خمسة وثلاثين صرافا، مقابل صراف مسيحي واحد وثلاثة من المسلمين. وكانت نسبتهم في غرفة تجارة بغداد قد قاربت النصف، وقد بلغ نفوذ عائلة زلخا من النفوذ المالي إلى الحد الذي راحوا فيه يقرضون الأموال للعائلة المالكة ونوري السعيد. ومن أبرز رجالات اليهود الذين تبوؤوا مناصب حكومية رسمية، يبرز ساسون حسقيل الذي تولى منصب وزارة المالية في العشرينات، وإبراهيم الكبير الذي عمل مستشار ماليا للعديد من الوزارات خلال ذات الفترة. وخلال الخمسينات من القرن العشرين، فإن حالة من التراكم الرأسمالي كانت قد تبدت لدى النخبة التجارية العراقية، حتى برزت عوائل فتاح باشا، في مجال النسيج والإسمنت والبنك التجاري العقاري واستخراج الزيت النباتي، وصناعة الأستبس وشركة المنصور للبناء والشركة الأهلية للتبغ. فيما برزت عائلة عبد الهادي الجلبي في مجال مطحنة للدقيق والمضاربة بالأراضي، وتجارة الحبوب، ووكالة شركة أندرو واير وتصدير التمور وتجارة الشعير. بالإضافة إلى عوائل غريبيان والدامرجي والخضيري ومرجان والصابونجي و مركريان وحنا الشيخ ولاوي وخضوري وبغدادي وحسو وآل حديد والصراف وحافظ القاضي والدهوي ومكية. وقد برز نشاط النخبة التجارية في مدن بغداد والبصرة والموصل والحلة.
التطور السكاني
شكلت المدينة إغراء للفلاح العراقي الذي عانى من البؤس والحرمان والضغط الشديد من قبل المشايخ الإقطاعيين ونوابهم ( السراكيل)، ومن واقع تركز المشاريع الصناعية في بغداد والبصرة، فإن نسبة الهجرة كانت قد تركزت إلى تلك المدينتين. حتى أن تعداد سكان بغداد قد بلغ في العام 1975 حوالي ا{بعة ملايين نسمة، فيما بلغ تعداد مدينة البصرة في ذات العام حوالي سبعمائة ألف نسمة. وقد شكلت نسبة سكان المدن في العراق خلال العام 1982 مايقارب 71%. مما يعكس حالة مريعة من الخلل السكاني، والذي راح يبرز آثاره على صعيد الانتاج الزراعي. وإذا ماتبقت البعض من سمات الريفية، فإنها تسللت إلى مجال السلطة السياسية. وكان العهد الملكي قد شهد سيادة لذوي الأصول المدينية في تولي المناصب الوزارية والإدارية العليا، لكن منذ العام 1958 تعرضت هذه المعادلة للتبدل، بدليل أن 80% من سكان بغداد خلال العام 1975 كانوا من أصول ريفية. ومن واقع انعدام الفرص للتحول الطبقي، كان الخيار وقد تركز عند المجال الأيديولوجي والانضواء في الحركات السياسية، تلك التي قيض لها أن تسيطر على مقاليد الأمور السياسية في البلاد عن طريق الانقلابات العسكرية والحزبية المتوالية. لاسيما بعد فشل العلاقة بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، حيث جاء إلى السلطة البعثيون في انقلاب فبراير 1963، بقيادة علي صالح السعدي، ليحدث الانقلاب عليه في ذات العام عن طريق عبد السلام عارف في تشرين 1963، حتى حادثة الطائرة التي أودت بحياة عارف عام في البصرة 1966، ليتولى منصب الرئاسة شقيقه عبد الرحمن عارف، وصولا إلى تموز 1968 حيث تمكن البعثيون من قيادة انقلاب بزعامة أحمد حسن بكر الذي بقي بمنصب الرئاسة حتى عام 1979، ليبرز دور صدام حسين رئيسا حتى سقوط بغداد على يد القوات الأمريكية في أبريل 2003.
سوريا المعاصرة
حرصت سلطات الانتداب الفرنسي إلى السيطرة على المتنفذين وكبار الملاك، من خلال إصدار المزيد من القرارات الإدارية المتعلقة بتنظيم الملكيات، حتى أنها أقدمت خلال العامين 1920- 1921 سلسلة من القرارات المتعلقة بالملكيات والتي جاءت متوافقة مع طبقة المتنفذين، حيث التطلع نحو جعل الأراضي الأميرية تحت سيطرة الدولة. لتمارس دور الراعي والمنظم لطريقة توزيع القوى داخل البلاد. وهذا ما تبدى واضحا خلال أحداث الثورة السورية 1925-1927، حيث ادعى المندوب السامي الفرنسي إلى أن سلطة الانتداب تسعى إلى تنظيم طريقة توزيع الأراضي، وبما يتوافق ومصلحة صغار الزارعين، وعبر إصدار مجموعة من القوانين، إلا أن هذا لم يكن سوى محاولة لمعالجة الحالة الاستثنائية التي نجمت عن الثورة، بدليل بقاء الملكيات الكبيرة في عموم مناطق سوريا. فخلال العام 1935 بقيت أراضي حلب في حيازة كبار الملاكين، كذلك الحال في حماة والسلمية وحمص. وبقيت الإدارة الفرنسية تسعى بكل جهدها للسيطرة على سياسة الأرض من خلال الحرص على إصدار العديد من القرارات والقوانين، التي يمكن من خلالها تعزيز سيطرتها على أصحاب النفوذ وبالتالي الحصول على قدرة في المناورة مع مجمل القوة الاقتصادية في البلاد.
على الرغم من ادعاء السلطات الانتدابية بسعيها نحو معالجة أراضي المشاع، من خلال توثيق ذلك في قانون صدر عام 1929، إلا أن العقبة التي واجهت الفلاحين الذين كان من المفروض الإفادة منه، قد واجهت مسألة الرسوم المفروضة على ترويج المعاملات الرسمية. حتى أن الإفادة المباشرة كانت تسير لصالح كبار الملاكين وأصحاب الأموال والتجار. وحتى العام 1933 بقيت الملكيات الزراعية الكبيرة هي الماثلة في مناطق حماه وحمص وحلب، فيما راح كبار الملاكين يسعون وبكل ما أوتوا من جهد نحو السيطرة على المزيد من الأراضي مستفيدين من فساد النظام الإداري الذي كان متفشيا في أجهزة الدولة. وكان العام 1932 قد شهد بيع أكثر من 250 قرية.
إن الغطاء القانوني الذي توفر لصالح كبار الملاكين، هيأ لهم الحصول على المنافذ التي تحقق لهم البروز السياسي، وحتى نهاية عهد الانتداب الفرنسي عام 1943، بقي كبار الملاكين يشكلون الأغلبية البرلمانية، فالنائب حراكي الذي انتخب في دورة عام 1936 كان يملك أربعمائة قرية. وقد استمرت الملكيات الكبيرة تمثل عصب الحياة الزراعية، فخلال العام 1955 بقيت هذه الملكيات تشكل نسبة 37%، أما الملكيات الصغيرة فلم تبلغ نسبتها سوى 17%.
يتبع




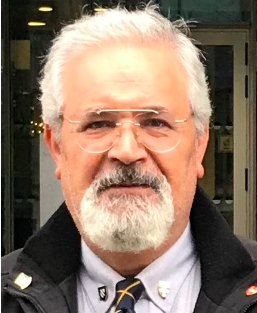
















التعليقات