انتهى العراقيون من وضع دستور لهم بعد مفاوضات ومساومات؛ ويستعد السودانيون لوضع هذا الدستور بعد توقيع اتفاق للسلام بين الشمال والجنوب؛ وينوي المصريون الحوار خلال الشهور القادمة حول مراجعة الدستور، والبعض منهم يريد تعديله، والبعض الآخر يريد تغييره.
ويمكنك ملاحظة أحوال الصوماليين وكثير من الأحاديث العربية وسوف تجد في كل مرة القول حول الدستور ووضع نظام الحكم. ويمكن بقدر غير قليل من اليقين القول إن هناك (لحظة) دستورية شائعة من الخليج إلى المحيط. فقد مل العرب غياب الدستور والقانون، واعتبار البعض له مجرد وثيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، فبعد كثير من الثورة والفورة والتمرد على الوثائق الجامعة أصبح من المعتقدات العامة أن الدستور والقانون هو الإطار الشامل الجامع لتنظيم أمور المجتمع وتنظيم العلاقات بين الحاكم والمحكوم والذي يجب إرساؤه على أسس سليمة.
ولم تكن هذه هي اللحظة الدستورية الأولى التي عرفها العرب، فقد عرفوها لأول مرة خلال القرن التاسع عشر، وأيامها كان معظم العالم العربي واقعا تحت الراية العثمانية، وكان خليفة المسلمين يحكم عن طريق فرمانات وولاة من مقعده في اسطنبول. وكان هذا الحكم تنظمه بعض تقاليد، وبعض عرف، وبعض فرمانات، وكان كل ذلك قليل ولا يعنى أكثر من سلطة استبدادية واسعة تشرف على سلطات استبدادية أخرى من جانب الولاة. هنا فإن السلطة لم تكن سلسلة من الحقوق والواجبات، والالتزامات، وقدرات المحاسبة للحاكم مهما كان اسمه ومرتبته في الهرم العثماني للسلطة. وجاءت اللحظة كما حدث في مصر خلال الثورة العرابية عندما باتت المطالبة بالدستور جزءا ليس فقط تحريرا من السلطة العثمانية وإنما أيضا جزءا من عملية المقاومة للغزو الخارجي. وانتشرت الجمعيات المدنية المختلفة في الشام والمطالبة بالدستور وحتى (الديمقراطية) حتى ولو كان بعض الناس لا يزالون يرون في الديمقراطية خروجا على الدين والملة.
وجاءت اللحظة الدستورية الثانية بعد الحرب العالمية الأولى، وهذه المرة كانت تركيا مهزومة في الحرب، وكان الخليفة العثماني قد تمت الإطاحة به، وكانت الولايات العثمانية المختلفة تريد الخلاص الممكن من دولة الخلافة، ومعه الحرية من المستعمر الأجنبي، وتحقيق الاستقلال في ظل القانون. وكانت النخبة العربية السياسية قد أعدت نفسها للحظة، فقد كانت كليات الحقوق والقانون قد انتشرت، وكانت الصحافة المكتوبة وحتى الإذاعة جزءا من الحياة العامة، وبشكل عام كان الفكر الليبرالي قد بدأ يطرق أبواب العالم العربي. ومع العشرينيات والثلاثينيات ولدت الدساتير المختلفة في مصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا. ورغم وجود الاحتلال فقد كانت الدساتير جزءا من عملية بناء الاستقلال، ولكن الأهم من ذلك كله بناء الدولة العربية العصرية.
ولكن اللحظة الدستورية في العالم العربي لم تكن أبدا سهلة فقد كانت الحرب واقعة عليها من جهات عدة، فلم يكن المستعمر سعيدا بها لأنها تطلق عقال الحريات العامة وتجعل المقاومة للمستعمر مشروعة، والأخطر - ربما - أنها كانت تضع المستعمر في مواجهة أخلاقية مع نفسه. ولا كان الملوك المستبدين ممن يجدون في الدستور وقدرته على تقييد حريتهم في اتخاذ القرار وتوزيع السلطة والثروة ما يسر، ومن ثم كان تعطيل الدستور - حيث كانت هناك دساتير - من الأمور المعتادة والمألوفة حتى ولو كانت مكروهة في كل الأحوال. ولكن المعضلة في وجه الدساتير لم تكن من المستعمر والملوك وحدهم بل كان أيضا قادما من حركات فاشية ودينية كانت معادية تماما لكل ما يقيد من هيمنة الدولة على المحكومين وسيطرتها على مقدراتهم، وكانت الدعوة لعودة الخلافة هي في جوهرها دعوة للاستبداد دون قيود من دستور أو قانون.
ومن الجائز تماما القول أنه كما كانت هناك لحظات دستورية في التاريخ العربي الحديث فإنه كانت هناك لحظات معادية للفكرة الدستورية، وجاءت هذه اللحظات خلال الخمسينيات والستينيات حينما تسارعت الانقلابات العسكرية في الدول العربية. ولم يكن العسكر من المتحمسين كثيرا لحكم الدستور، ولو كان ذلك ضروريا فقد سادت الدساتير المؤقتة، والقوانين الانتقالية، وفي أحيات كثيرة وضعوا عددا من المواثيق المنافسة للدستور مثل (الميثاق) الوطني. وبينما كان القادة والزعماء الذين يتحدثون كثيرا يشيرون دوما إلى هذه الوثائق الأخيرة فإننا لا نجد إلا نادرا إشارة للدستور. وكان ذلك سببا في فرح المعادين للفكرة الدستورية الممجدين لدولة مهيمنة ، بل يمكن القول أنها كانت سببا في ضمور رجال القانون والدستور وتواضع قدراتهم، بل وضمور التأييد الشعبي للفكرة ذاتها. وربما كان ذلك هو أهم نقاط الضعف في اللحظة الدستورية الراهنة حيث تأتي بعد فشل اللحظة الثورية اللادستورية السابقة، وهي تأتي دون نصير واسع من الجماهير. ولعله يفسر حالة الهجوم الساحق التي تتعرض لها عملية وضع الدساتير في السودان والعراق واتهامها منذ البداية على أنها (طائفية) أحيانا، وقيامها بتفتيت الدولة أحيانا أخرى، وجعل الدولة مخترقة من القوى الأجنبية أحيانا ثالثة. ففكرة قيام تعاقد جديد قائم على الرضا بين الحاكم والمحكوم تبدو شيطانية لدى كثيرين استسلموا إلى أن جوهر النظام السياسي هو الخضوع والاستسلام لقوى حباها الله قدرات على القيادة وحمل رسالة مقدسة من نوع أو آخر. والأكثر شيطانية من هذه الفكرة تصور ضرورة التعاقد والتراضي والتوافق بين جماعات الشعب المختلفة على مراعاة بعضهم البعض في موضوع الهوية وتوزيع السلطات والثروة بينهم بالعدل. وخلال عملية وضع الدستور العراقى الجديد كان هناك كثيرون في العالم العربي يشعرون بالامتعاض بسبب إصرار الشيعة - العرب - والأكراد على عدم النص في الدستور على أن العراق جزء من الأمة العربية واكتفائهم بذكر أن العراق دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وملتزمة بميثاقها.
وكانت تلك هي الصيغة التي توافق عليها أكثر من 80% من العراقيين، وقد يحبها البعض، ويكرهها البعض الآخر، ولكنها كانت الصيغة المناسبة للتراضي العراقي في اللحظة الراهنة. فكرة التراضي والتوافق هذه تبدو هي المعضلة الكبرى أمام الفكر الاستبدادي حسب طبعاته المختلفة الدينية والقومية والتي تتصور أن الدولة ليست عقدا اجتماعيا وسياسيا بين الناس وإنما هي حالة من التفويض الإلهي أو القدر التاريخى، أو حالة من السيطرة والهيمنة على مصائر العباد من قبل المفوضين من السماء أو من (الجماهير)!. ولذلك فربما كانت هناك حاجة ملحة في الدول العربية لبعث الفكر الدستوري من جديد، وتقوية مدارس القانون بل وفكرته باعتباره منظم حركة المجتمع والعلاقة بين الحكام والمحكومين. ولا أظن أنه من الممكن ترسيخ الديمقراطية، وأفكار مثل قبول الآخر والدفاع عن الحريات العامة ما لم تكن اللحظة الدستورية قائمة وممتدة إلى فكرة اللحظة القانونية، فالحكم بين الناس في الدولة الحديثة ليس العرف، وليس التقاليد، وليس الأيديلوجية، وليس مصالح الشعب العليا، ولا ضرورات الأمن القومي، وإنما القانون والنصوص الدستورية.







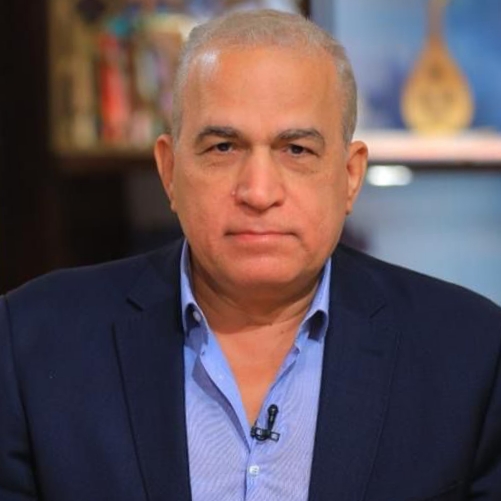







التعليقات