صلاح سالم
لم يكن أكثر المصريين تشاؤماrlm;,rlm; أعقابrlm;25rlm; ينايرrlm;,rlm; يتوقع أن تشهد مصر كل ما رأيناه ولا نزال علي ساحتهاrlm;,rlm; وأن تقودنا ثورة تحررية طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية ناهيك عن العدالة الإجتماعيةrlm;,
إلي دولة إخوانية( مرشدية) ترعي فهمها الخاص للدين, ويدعو رئيسها للجهاد مثل أمير جماعة, ويقوم زبانيتها بعمليات قتل وترويع باسم الدين تم خلالها سحل نفر من الشيعة لمجرد أنهم شيعة, كما تم سحل مواطنين لمجرد أنهم غير إخوانيين, وقتل مصريين لفقط لكونهم معارضين.
لقد أسقطت تلك الدولة سياسيا بفعل موجة جديدة من الثورة المصرية الفتية, ولكن بنيتها الثقافية تكاد تكون باقية, ومن دون تفكيك تلك البنية المؤسسة لها سنظل نواجه خطر عودتها, وهو أمر يقتضي تجديدا للفكر الإسلامي, يؤسس إصلاحا دينيا, ونهوضا وطنيا طال انتظاره.
اليوم تعمل' فكر' بعض معاول التفكيك النظري في هذه البنية الثقافية الراكدة بأيدي رجال ثلاث: يحمل المعول الأول الشيخ المستنير د. محمد عبد الفضيل القوصي, عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف, هادما تطرفات الإدراك الإسلامي للعقيدة التوحيدية, مقترحا المذهب الأشعري في صورته النقية لتجديد فهمنا للإسلام, معتبرا أنه الأقرب للشخصية المصرية البسيطة والواضحة, وذلك علي صعيد قضايا ثلاث تتعلق بمفاهيم: الإيمان, التنزيه, التوحيد.
ويحمل المعول الثاني د. محمد فايد هيكل الأستاذ بجامعة الأزهر, هادما لسلطة دعاة الدين والتدين, داعيا إلي إعادة بناء المفكر الإسلامي المسئول القادر علي إظهار ما في الإسلام من سماحة واتساع وبعد عن ضيق النظرة والتعصب للمواقف المذهبية في الحكم علي الوقائع والمشكلات من خلال سياقها الخارجي, وعلي قراءة النصوص في مجموعها قراءة واعية تحقق الخير العام للبلاد والعباد.
أما المعول الثالث فيحمله كاتب هذه السطور, داعيا إلي هدم الموروث القديم, لعلم الكلام الإسلامي, ذلك الذي دار حول قضايا غيبية أهمها الذات والصفات, واتخذ طابعا سجاليا عقيما أهدر نقاء الرؤية القرآنية للوجود, ومقترحا المذهب المعتزلي طريقا للتجديد, يراه منطويا علي إمكانية كبيرة لثوير العقل الإسلامي من داخل الإيمان التوحيدي, بشرط إعادة بناء مفهوميين أساسيين لديه يدعمان التوجه نحو العقلانية والحرية: الأول هو مفهوم( القصدية) الذي يفتح نافذة كبري يطل منها النص القرآني مباشرة علي العالم, بحثا عن غايات الله فيه, وبحثا عن إجابات جديدة علي أسئلة الواقع المستجدة.أما الثاني فهو مفهوم( اللطف), الذي يحاول التأليف بين الحضور الإلهي في الكون, وبين الإرادة الإنسانية في التاريخ, فاتحا الطريق أمام جماع القيم التحررية والديمقراطية.
المدخل المعتزلي.. تحرير العلاقة بين النص والعالم!
ثمة مسلمة رائجة في التاريخ الثقافي تعتبر الأديان, علي تنوعها, ربيبة للعالم الكلاسيكي السابق علي الحداثة, تلك التجربة/ الطفرة التي بلغها التاريخ الإنساني علي أشلاء الرؤية التقليدية للوجود وفي قلبها الأديان. وهكذا تصير الأديان هي النقيض المنطقي للروح الحديثة, وخصوصا إذا ما فهمنا الجوهر الفلسفي للحداثة باعتباره ذلك التحول الجذري علي صعيد تصور الذات الإنسانية لموقعها في الوجود, وقدرتها علي التحكم في مصيرها وانعتاقها من الأفكار ذات الطابع الأسطوري أو الميتافيزيقي التي طالما أعاقت قدرتها علي النمو الذاتي والتحرر الوجداني, وخاصة تلك الأفكار التي ادعت بالحق الإلهي المقدس في حكم الشعوب ما كان كفيلا بإلغاء كل ركيزة عقلانية, وقيمة موضوعية, ينتجها أو يراكمها التاريخ البشري علي طريق التقدم. ولكن يبقي السؤال.. هل كانت كل الأديان نقيضا لحركة الوعي البشري نحو التعقل, أو قيدا علي حرية الإرادة الإنسانية نحو التحرر؟.. هل كان التناقض محتما بالضرورة, أو كان القيد مطلقا يتجاوز الزمان والمكان؟..
يدعي كاتب هذه السطور أن الإسلام ـ كنص ـ يستند إلي المباديء الكلية للعقل, ويحوز من البداية' روحانية حديثة' تخط مساراتها العميقة انطلاقا من مفهوم' الذات المستخلفة' الذي يحكم العلاقة بين الله كقطب أول خالق للوجود, وبين الإنسان كقطب ثان مخلوق علي رأس الوجود, خليفة لله في الكون. هذا المفهوم( الذات المستخلفة) يمثل تأسيسا لحرية الإرادة الإنسانية إذ يزيل من أمامها كل قيد يعطل انطلاقها أو طموحها إلي العمل والإجتهاد والإبداع, وتشييد الأبنية الحاضنة والقواعد المنظمة لهذا العمل بشرط واحد هو استلهام معناها النهائي من الرؤية الإيمانية للوجود وهو المعني الذي يتنزل من السماء لا ليحكم الحياة بكل تفاصيلها الدقيقة: أبنيتها ومؤسساتها وعلاقاتها, وأشكال تنظيمها الاجتماعي والسياسي إخضاعا لها, عند التطبيق العملي والممارسة التاريخية لسلطات قاهرة, بل فقط ليلهمها غايات الوجود النهائية التي يفسد الكون بغيابها, ومحررا لها من كل سطوة أرضية ترفض هذا الإلهام وناصرا لها علي كل سلطة بشرية تبغي الفساد في الأرض حتي وإن تسترت بلباس الأديان نفسها في قشورها وقوالبها البالية, إذ تتحدد هذه الغايات الأساسية في ضوء الإدراك' العقلي' للدين والمتطور في التجربة الإنسانية وليس في ضوء الإدراك' البدائي' للدين والمتجمد عند الأشكال والقوالب التاريخية.
وفي تصوري أن' علم الكلام'( المعتزلي) يستبطن داخله ممكنات الإدراك العقلي للإسلام, وينطوي علي إمكانية كبيرة لثوير العقل الإسلامي من داخل الإيمان التوحيدي, شرط القدرة علي إعادة بناء هذا العلم( الكلام) وذاك المذهب( الاعتزال), علي نحو يجعل توجهه الأساسي نحو المستقبل وليس إلي الماضي, باتجاه القضايا الجدلية الموروثة عن هذا العلم.
ما يميز علم الكلام باعتباره( فلسفة إسلامية), عن الفلسفة الخالصة, كنشاط مؤسس للعقل الإنساني, هو انطلاقه من مبدأ أول' مطلق' يقول بالألوهية مصدرا لكل حقيقة, فيما العقل آداة كشف عنها, أي فهمها وتأويلها, وليس أداة خلق لها, بينما تقول الفلسفة بوجود مطلقين متجاورين هما العقل والوحي, لا يخضع أحدهما للآخر, بل وتنفي بعض تياراتها الملحدة حقيقة الوحي تمجيدا للعقل, فيما تذهب تياراتها المؤمنة إلي وجود حقيقتين: دينية وفلسفية مستقلتين, ولكن مع إمكانية تكاملهما.
أسمي علم الكلام بهذا الإسم لأنه بدأ بالجدل أو' الكلام' حول الذات الإلهية, في محاولة دءوبة للدفاع عن العقيدة ضد الملحدين لها, وتنزيه الله لدي المؤمنين بها عن أي تشبيه, أو تجسيد, ولذا كانت أبرز معاركه هي قضية الذات والصفات, ثم خلق القرآن, وإن تمددت بعد ذلك إلي قضايا القدر والحرية والجبر والمسئولية الفردية وغيرها.
وبرغم معاركه المجيدة في القرون الأولي دفاعا عن العقيدة الإسلامية وأصولها الراسخة, ما يفسر تسميته الثانية بعلم( أصول التوحيد), فإنه; بنزوعه إلي التجريد, وخوضه في مسائل غيبية مفارقة تعلو علي العقل, قد استنزف طاقات الفرق الإسلامية في سجالات عقيمة تشبه السجالات السوفسطائية التي جسدت أزمة الفكر اليوناني بعد غروب شمس مدارسه الكبري خصوصا الأثينية, وأعاقتها عن التطور في المسار الذي أخذه العقل الأوروبي الحديث, أي نحو دراسة الطبيعة وممارسة التجريب العلمي, خروجا من قبضة المنهج الإستنباطي الذي هيمن علي الأفق المعرفي للقرون الوسطي ووضع حدودا لتطورها. بل إنه عجز تدريجيا عن القيام بالدور الحيوي المأمول في الحياة الجوانية للإنسان المسلم, ما يفرض علينا إعادة بناء منظومة كلامية جديدة تتجاوز المماحكات النظرية, والقضايا الجدلية الموروثة الموروثة عن هذا العلم, باتجاه مستقبلي, وبالذات نحو مفهومي' العقلانية'و'الحرية', والتي كان متكلموا المعتزلة قد نجحوا في صياغتها باقتدار, قياسا إلي النزعة الجبرية الأكثر رجعية لدي الجهمية من ناحية, والفلاسفة الذين تأثروا عميقا بالروح اليونانية من ناحية أخري, وخصوصا ابن رشد الذي اعتقد, متأثرا بأرسطو في مبدأ ثنائية الحقيقة, كما أبدي اقتناعا بمبدئي قدم العالم, وعدم شمول العناية الإلهية للأفعال الفردية. وهنا يمكن التوقف عند مفهومين معتزليين, يؤسس أولهما للعقل, وثانيهما للحرية.
الأول هو مفهوم( القصدية) الذي اعتبره القاضي عبد الجبار شرطا لفهم الكلام الإلهي, لكنها ليست تلك القصدية المستنبطة من الكلام ذاته( النص), بل القصدية النابعة من الفهم العقلي للعالم خارج النص أو اللغة, والمضمنة في( الكون أو الواقع), إذ يربط الإسلام بين نوعين من الآيات: آيات الله الملفوظة, القرآن الكريم, وآيات الله المشهودة أي( العلامات الكونية), التي بثها في الطبيعة من حولنا, وطلب منا تدبرها, حيث تصير الطبيعة رموزا يتحدث من خلالها المؤلف الكلي( الله).
ولعله صحيحا أن النوع اللفظي من الآيات, أي القرآن الكريم, يجسد الإرادة الإلهية بصيغة أكثر تعينا إذ تشير إلي ما يريده الله بأكبر قدر من المباشرة والإحكام, قياسا إلي الآيات الكونية, حيث تكشف الإرادة الإلهية عن نفسها علي نحو غير مباشر لا يتوفر علي هذا الإحكام, فإن الأخيرة تملك ميزة واضحة, إذ بإمكانها أن تخاطب البشر عامة, من دون أي تقييد. كما أنها تثير فينا رغبة التأمل لا ملكة التلقي, ومن ثم تصير معطي مباشرا للعقل لا تستلزم نقولا ونصوصا تقوم بدور الحاجز أو الوسيط بين الإنسان والعالم.
وهكذا يتيح لنا مفهوم القصدية قدرة كبيرة علي التجديد الفكري تفوق كثيرا تلك التي يتيحها مفهوم التأويل, إذ بينما يتمحور الأخير حول العلاقة بين( المحكم) و( المتشابه) لتوسيع النافذة التي يطل منها النص علي العالم, تعويلا علي العقل, يقوم الأول مباشرة بوضع العقل في مواجهة العالم خارج النص, بحثا عن غايات الله فيه, وهي المهمة التي تفرضها مسئوليته كخليفة, أي كائن حي متطور, يحتاج دوما إلي إجابات مستجدة علي أسئلة قديمة عبر' التأويل', وكذلك إلي إجابات جديدة علي أسئلة جديدة بالكلية عبر' القصدية'.
أما الثاني فهو مفهوم( اللطف), والذي يمثل مسعي عقلي يحاول التأليف بين الحضور الإلهي في الكون, وبين الإرادة الإنسانية في التاريخ, أي بين الأمر الصادر عن الله' كتكليف ديني', وبين السلوك المتولد عن الإنساني كـ' إرادة حية' تود الاضطلاع بمسئولية أفعالها. فالله جعل الإنسان حرا لأنه عاقل, حيث ترتبط الحرية بالاعتقاد في الكفاءة التامة للعقل البشري, أو كما يسميه روسو( القابلية إلي الكمال), شرط أن نفهم ذلك الكمال باعتباره القدرة علي تحقيق تقدم أخلاقي مطرد في التاريخ, وليس بلوغ حال الإكتمال التي تبرر الإستغناء والإكتفاء, المرتبطين بالحقيقة القدسية المتسامية والمتعالية علي التاريخ. لكن, وفي المقابل فإن الحرية الإنسانية تواجه أنواء عاصفة, وتحديات عاتية تغمي علي العقل الإنساني, وتحول دون قدرته علي إدراك الخير الذي يتفق والمشيئة الإلهية, ومن ثم تصبح أقدارنا نتاجا للصراع بين قوتين; فثمة قوة خلاقة تتمثل في المشيئة الإلهية. وثمة قوة شريرة منسوبة إلي الشيطان وإن كانت تتموضع في العالم من حولنا أو حتي في داخلنا, حيث تكمن غرائزنا ورغباتنا.
غير أن الله لم يترك الإنسان لعقله وحده بل أنعم عليه ولطف به. هذه العناية تأخذ أحد مظهرين أولهما هو الوحي, الذي يرسم مسارا لبلوغ الحق, يساعد العقل ولكن من دون أن يحل محله. وثانيهما هو العناية الإلهيه لأفعالنا الفردية, وهو ما نحوزه ابتداءا بالدعاء إلي الله كي يدعم جهودنا للإنتصار علي الشر, ونعول عليه انتهاء بالتوبة إليه حال وقعنا فعلا في الشر, فطالما تيقنا من أن الله موجود, وأن التوبة ممكنة, تحرر الإنسان من الخوف المطلق, واندفع إلي تأكيد حضوره, وممارسة اجتهاداته, ضامنا أجر المخطيء, علي نحو يمنحه شعورا عميقا بالثقة, ورغبة دائمة في التجريب سواء العلمي سعيا إلي العقلانية والتقدم, أو في السياسة نزوعا إلي الديمقراطية والتحرر.








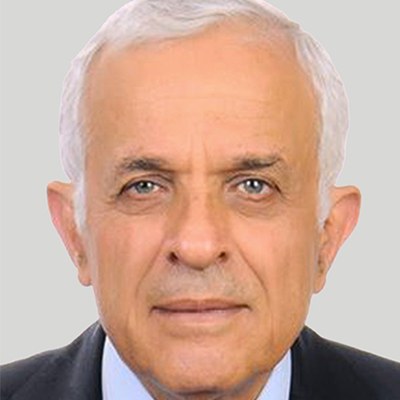











التعليقات