عبدالله جمعة الحاج
عادة ما يتم فصل التاريخ الإسلامي من ناحية دينية عن الأيديولوجيا الحديثة، وتاريخياً انقسم المجتمع الإسلامي في وقت مبكر إلى مجموعتين رئيسيتين، هما السنة والشيعة. وعلى من الرغم أن هاتين المجموعتين تتشاركان في المعتقد نفسه، وتجمع بينهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن كلتاهما تختلف عن الأخرى بطريقة ما في نظرتها للتاريخ والسياسة والحكومة. لقد حصل الانشقاق حول مسألة تولي السلطة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمن الذي يجب أن يقود المجتمع الإسلامي؟ الأغلبية السنية، متبعة الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسم وريثاً له، قبلت بعملية اختيار أو انتخاب الخليفة على أنه السلطة السياسية العليا أو رأس الدولة.
أما الشيعة، وهم المناصرون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاعتقدوا بأن الرسول فرز ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب على أنه وريثه، وبأن قيادة المجتمع كان يجب أن تكون محصورة في آل البيت. ووفقاً للشيعة فإن من انحدر من آل البيت، خاصة من سلالة علي، كان يجب أن يصبحوا القادة الدينيين والسياسيين أو أئمة المجتمع الإسلامي ودولته. وعليه فإن صيغتين من الحكومة الإسلامية ظهرتا في بداية مسيرة المجتمع المسلم، هما الخلافة السنية والإمامة الشيعية.
وعلى مدى التاريخ الإسلامي، حافظت الأغلبية العظمى من المسلمين على مذهبها كسنة، وهم يشكلون الآن خمسة وثمانين بالمائة من مسلمي العالم. ومع وجود استثناءات قليلة، كما هو في إيران اليوم، فإن الشيعة بقوا مواطنين في الدول التي يحكمها السنة، وبقيت الإمامة نظرية دينية سياسية أو فكرة ربما يتم تحقيقها في تاريخ قادم مع ظهور شخصية مختفية هي المهدي المنتظر أو الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة. وهي فكرة خيالية ليس لها سند يعتد به في الأدبيات الإسلامية المسندة والصحيحة وربما تجافي الطبيعة البشرية من منطلق حقيقة عودة الإنسان إلى الحياة في هذه الدنيا بعد موته.
وبالنسبة للسلطة السياسية لدى الشيعة، فهي تتركز في الفقيه الولي، أي تقوم على ولاية الفقيه، وهنا يوجد في تقديري لبس شديد يخيم على فهم طبيعة ممارسة الدولة للسلطة السياسية، إذ يغيب عن أذهان الكثيرين أن السلطة جاءت نتيجة لخوف الإنسان وبحثه الأزلي عن الأمن. ومنذ ذلك الوقت برزت ظاهرة السلطة الخطيرة والأساسية في حياة المجتمعات الإنسانية، ومن دون أدنى شك فإن حصرها في يد الولي الفقيه وحده يعيق تطور المجتمع. فمع مسيرة المجتمع نحو الأمام لابد وأن يتطور مفهوم السلطة أيضاً. وهنا فإن سلطة الدولة بمفهومها الشامل تعلو فوق كل سلطة أخرى بداخلها، والسلطة السياسية هي حجر الأساس بالنسبة للدولة العصرية وما يوجد فيها من مؤسسات، وبغير السلطة السياسية لا تقوم للدولة ذاتها قائمة، ولا يمكن أن توجد لدى البشر أنظمة سياسية أو حتى حياة سياسية. ونتيجة لذلك فمن الصحة بمكان الإشارة إلى أن الحياة السياسية في الدولة تتمحور جميعها حول ذلك المركب المعقد من العناصر المادية والمعنوية الذي يسمى السلطة، أي سلطة الدولة وليس الفرد سواء أكان فقيهاً أم قطباً سياسياً أياً كان حجمه. والواقع أن السلطة الحقيقية تتمثل في اعتقاد واقتناع أفراد المجتمع بأنها هي التي توفر لهم في مجموعهم ما يحتاجونه من أمن مادي وسيكولوجي. فإذا ما تحولت إلى نوع من القهر المادي الذي يتم تركيزه في يد الولي الفقيه فإنها تدل في هذه الحالة على عدم استقرار الدولة، وربما تتحول مع مرور الوقت إلى مرض من أمراض السلطة وليست كظاهرة طبيعية.
&








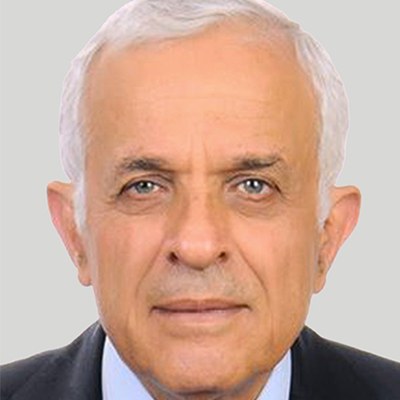











التعليقات