مالك التريكي
حتى إعلان نتائج الانتخبات البرلمانية التي عقدت الأسبوع الماضي لم يكن التونسيون قد غنموا من الثورة، بعد حوالي أربعة أعوام على اندلاعها، أي شىء سوى حرية التعبير. أما بعد الانتخابات، فقد ثبت أنهم تمكنوا من أن يغنموا شيئا ثانيا عزيز المنال في إقليم منكوب بالحكم العسكري أو الملكي غير الدستوري: إنه التداول السلمي على السلطة.
ولا شك أن الغنم الثاني هو أثمن وأركز في الترسيخ العملي لتجارب الممارسة الديمقراطية لأنه شرطها الضامن لإمكانية استمرارها. شرط إجرائي في الشكل ولكن مجرد توفره، ناهيك عن الثبات عليه، إنما يتوقف على تحوله شرطا ثقافيا في الجوهر. ذلك أن التداول السلمي على السلطة هو بذرة العملية الديمقراطية كما أنه ثمرتها. أما حرية التعبير فإنها، على بالغ أهميتها حقا إنسانيا وسياسيا أساسيا وعلى جليل خطرها حرية مبدئية فاتحة لجميع الحريات العامة، تظل رغم ذلك أيسر منالا. إذ سبق لأنظمة غير ديمقراطية، ولكنها على قدر من الليبرالية، أن أتاحت هامشا معقولا من حرية التعبير، مثلما كان الأمر على سبيل المثال في مصر بين الحربين العالميتين أو في الكويت حتى بداية التسعينيات، أو في تونس في بدايات حكومة محمد مزالي أوائل الثمانينيات. على أن من البديهي أن حرية التعبير (وما يتفرع عنها: حرية الصحافة وحرية النفاذ إلى المعلومات) لا تضطلع بدورها الأقوم والأدوم إلا في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية، لأنها تكون آنذاك أقوى دعائم النظام وأول حماة الحريات والمؤسسات.
فماذا يعني ما أثبتته الانتخابات من بداية شيوع ثقافة التداول السلمي على السلطة في تونس؟ إنه يعني شيئا بسيطا، بل بديهيا، في المجتمعات ذات الثقافة الديمقراطية، ولكنه ثوري حقا في المجتمعات الخارجة للتو من قرون من التسلط: وهو أن ماكينة المجتمع السياسي قد بدأت تعمل وتدور فعلا حسب آلية التكليف الشعبي المحدود بأجل (وليس بآلية الزواج الكاثوليكي أو الشيك على بياض). وبهذا تكون الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، بقبولها هذا التكليف أو التفويض، قد قبلت بأن تحمل على عاتقها ما يسميه الفرنسيون «عبء النتيجة”: أي مسؤولية تحقيق المطالب الشعبية.
أما أهم الدروس المستفادة من الانتخابات على المدى المستقبلي البعيد، فهي أن المشهد السياسي التونسي قد صار متشكلا من حزبين رئيسيين كلاهما من اليمين: حزب محافظ اجتماعيا وليبرالي اقتصاديا (النهضة) وحزب ليبرالي اجتماعيا واقتصاديا (النداء). أما بقية الأحزاب، فلا تفسير لكثرتها العبثية ولتشرذمها الانتحاري إلا عناد كل “زعيم” في التمسك النرجسي بوهم زعامته. والحال أنه إذا أرادت هذه الأحزاب أن تبقى على قيد الحياة انتخابيا فإنها لا بد أن تتوحد، أو على الأقل أن تتحالف، تحت مظلة حزب واحد. ولكن المسألة لا تتعلق بمجرد البقاء على قيد الحياة والقدرة على “التنفّس” الانتخابي، أي التنافس مع الحزبين الرئيسيين على السلطة، وإنما بمضمون المشروع المطروح.
فما الذي تحتاجه بلاد فقيرة يبدو في الظاهر أن حزبيها الرئيسيين متعارضان إيديولوجيا ولكنهما في الواقع متفقان على صعيد الأخذ بالنيوليبرالية وبوصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و”إجماع واشنطن” علاجا للمشكلات الاقتصادية؟ إنها تحتاج لحزب كبير في نفس وزن أحد هذين الحزبين اليمينيّين، على أن يقارب مشكلات المجتمع من منظور العدالة: حزب يندرج في سياق الأفق العام للديمقراطية الاجتماعية، أو ما شاع ترجمته في الأدبيات العربية بـ”الديمقراطية الاشتراكية”.
ونظرا إلى أن معضلات تونس الكبرى تنموية، فإنه لن يكون لأي حزب طامح لمنافسة الحزبين اليمينيين من معنى سوسيولوجي إلا إذا كانت عقيدته المركزية هي العدالة الاجتماعية. وعلى هذا فإن أمام أحزاب يسار الوسط، وخصوصا الجبهة الشعبية، تحديا تاريخيا يجدر بها أن تواجهه: أن تبدأ بالتحالف في ما بينها ثم تبادر إلى دعوة الأحزاب الصغيرة الأخرى للانضمام إليها على أساس برنامج ملتزم بمبادىء الديمقراطية الاجتماعية ولكن فيه من المرونة وسعة الأفق ما يسمح بتأليف إرادات جميع التقدميين. أما إذا استمرت نرجسية الزعامات الوهمية حائلة دون إمكانية بروز قوة ثالثة، في شكل حزب تقدمي كبير، فستظل البلاد محرومة من المستقبل. ولا مستقبل إلا في تجنيد جميع طاقات العلم والعمل والجدارة للنسج على منوال تنمية قائم على التكافل الاجتماعي.






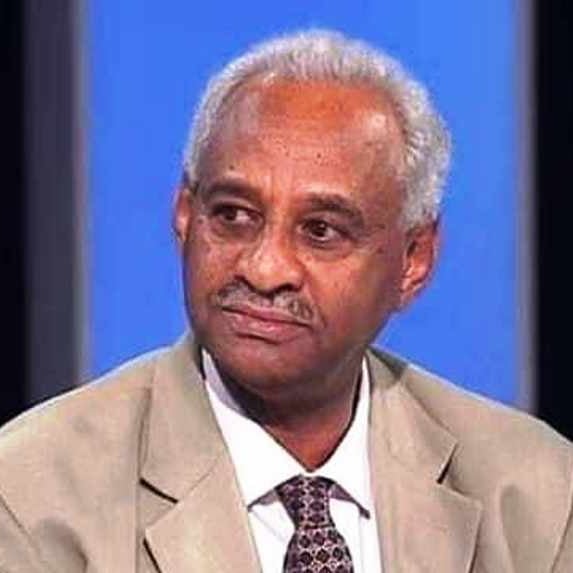














التعليقات