&
&
&.jpg) رامي زيدان
رامي زيدان
في العام 1982 أصدر الشاعر السوري الرحل نزار قباني ديوانه "بلقيس"، تضمن قصيدة في رثاء زوجته: "شكراً/ لكم./ شكراً لكم./ فحبيبتي قُتلت. وصار بوسعكم/ أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة/ وقصيدتي اغتيلت./ وهل من أمةٍ في الأرض/ إلا نحن - تغتال القصيدة؟/ بلقيس...".
هذه القصيدة نشرها قباني بعد عام على مقتل زوجته الديبلوماسية بلقيس الراوي في تفجير السفارة العراقية في بيروت. بعد سقوط رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي، تقدم ذوو بلقيس بدعوى قضائية يتهمون فيها المالكي الذي ينتمي الى حزب "الدعوة" الإسلامي بأنه وراء التفجير الإرهابي ("المستقبل"، الثلثاء 19 آب الجاري). ليس مفاجئاً اتهام المالكي بالمشاركة في تفجير السفارة وقتل بلقيس والعشرات معها، فهذه المعلومات متداولة من زمن في المقالات والتحقيقات والتسريبات المخابراتية.
لكن مَن يحاسب مَن في زمن المعمعة وانبعاث المارد الطائفي والمذهبي، بعدما صار المالكي "بطلاً" في عيون مناصريه. وكان تفجير السفارة جزءاً من سلسلة تفجيرات انتحارية حصلت في لبنان والعراق ضد مصالح أجنبية، فرنسية وأميركية، وعراقية صدامية. يومذاك لم يكن تنظيم "القاعدة" قد ولد بعد.
العودة الآن إلى بلقيس، ليس لأنها زوجة شاعر الحبّ والغزل الذي أصدر ديوانه الشهير عنها، بل لأنها قُتلت في تفجير ربما من أوائل التفجيرات الانتحارية (الاستشهادية كما يسمّيها الإيديولوجيون) في المنطقة. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود على مقتل بلقيس، تعيش هذه المنطقة والعالم مرحلة الرعب من وحش التطرف الإسلامي، بعدما صارت التفجيرات الانتحارية أشبه بعمل "روتيني" للمنظمات الاحترابية والارهابية والميليشيوية. المالكي، المتهم بتفجير سفارة بلاده في بيروت، كان وصل الى رئاسة الحكومة العراقية بعد الغزو الأميركي وإسقاط صدام.
رفعوا صوره في بيروت باعتباره بطلاً من أبطال المقاومة، من دون الانتباه إلى أن العراق تمزّق في زمنه وتفكك إرباً. أضاف المالكي الى العراق جحيماً جديدة فوق الجحيم التي زرعها صدام. أُسقط المالكي بتوافق دولي بعدما مارس كل السلوكيات الطائفية الفجة والفظة. ذهب به الخارج كما سبق له أن أتى به. كانت "القاعدة" تنفذ عمليات إرهابية، لكنها قبل سقوط المالكي احتلت نصف العراق وأثبتت هشاشة البنيان العراقي. سيطرت على أراض شاسعة من العراق وسوريا، وباتت تتلذذ بقطع الرؤوس والتهجير والذبح بالسكاكين، وتجلى ذلك بقوة في ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي في سوريا في مشهد هوليوودي واقعي أرعب العالم.
&البدايات
نعود إلى البدايات، الى تفجير السفارة العراقية في بيروت لنلتقط جوانب من أسس "الداعشية" "الثقافية" و"السياسية" التي تفتك بنا. ليست "الداعشية" الراهنة ابنة الدين كما يتوهم البعض، وليس الدين ببريء من أن يكون مصدراً من مصادر جنونها. المعضلة أن لدى الكثير من "الداعشيين" ارتباطاً بـ"سحر" وحشية هذا التنظيم، وليس لأنه يحمل الراية الإسلامية السوداء ويريد تطبيق نظام الخلافة. فهم بالكاد يعرفون أركان الاسلام، وهذا ما بيّنته بعض وسائل الاعلام الأجنبية. وعلى هذا، "داعش" هو الوحش الذي ربّته الدول الكبرى على مراحل. سمّنته جيداً الى درجة أصبح فرانكشتاين الذي يتمرد على خالقه. ربما تدرك الاستخبارات الدولية أنها من خلال شدته ووحشيته تجبر الدول الشرق أوسطية على إيجاد حلول، من أزمة الحكومة العراقية إلى حالة القلق في لبنان والخليج...
أين بدأت القصة وأين تنتهي؟ في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، كان المشرق العربي (وربما العالم) يعيش مرحلة صدمات جديدة وتبدلات صاعقة تظهر نتائجها وافرازاتها الآن، وتجعل كل شيء أشبه بالرماد، بدءاً باغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط عام 1977، فخطف السيد موسى الصدر عام 1978. كان قتل الأول وخطف الثاني نوعاً من تفريغ البلد من أدواره. وفي العام 1979 عاش ملالي إيران زهو الثورة الإسلامية، وبعدما أمضى الخميني أعواماً في المنفى الباريسي محاطاً بالمثقفين عاد الى قم وصار محاطاً برجال الدين. استبعد المثقفين أو فتك بهم واختار نظرية "تصدير الثورة" (الإرهاب) و"ولاية الفقيه" وصوّب عينيه نحو دمشق وبيروت لإطلاق "الثورة الإسلامية"، وغزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان عام 1979 الذي شكل منطلقاً لانبعاث حركات طالبانية و"جهادية" (إرهابية لاحقاً) استقبل قادتَها الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في البيت الأبيض ووصف عناصرها بـ"أبطال الحرية". وهذا سبقه بدء الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) اذ فجّر انصار حزب "الدعوة" عام 1980 قنبلة في جامعة المستنصرية ببغداد اصابت طارق عزيز فوعد صدام بالانتقام. واشتعلت حرب الخليج الأولى التي كانت بداية لتدمير العراق. بدأت الحرب عام 1980 في العراق ولم تنته حتى الآن، فبقي العراق في مستنقع المآسي والدواعش بمختلف ألوانها.
قُتِلت بلقيس في مرحلة ذهاب الرئيس المصري أنور السادات الى كامب ديفيد في عملية السلام مع اسرائيل واغتياله لاحقاً على يد جماعة "الأخوان المسلمين" العام 1981 تاركاً فراغاً في السياسة العربية، لم يُستعد حتى الآن. حصلت مصر على ارضها وبقيت فلسطين في مستنقع التهويد والتدعيش، رهن الاصوليات المتناقضة.
في المرحلة نفسها حصل الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982 الذي قتل حداثة المدينة اللبنانية وشتّت تنوعها وشكل أرضاً لولادة "حزب الله". "الداعش" الإسرائيلي قتل بيروت قبل أن تجهز عليها الطوائف.
أن نقول بداية الثمانينات، فهذا يعني بداية سباق الاصوليات أو التطرف أو "الهويات القاتلة"، وتفجير السفارة العراقية لا يمكن فصله عن الصراع الشيعي - السني (المقنّع بحزب البعث يومها). وبالتزامن مع تفجير السفارة العراقية اغتيل نقيب الصحافة رياض طه (1927 – 1980) واغتيل شاعر الزجل موسى شعيب (1943 – 1980) بسبب ولائه لحزب البعث العراقي، أحيانا يتم ذكر رياض طه في وسائل الاعلام أما موسى شعيب فيبدو كأنه من عالم آخر.
مع صعود "الجهاد الشيعي" (المهدوي) في إيران كان صعود الجهاد السنّي (السلفي، لاحقاً القاعدي) في أفغانستان ومناطق أخرى. كانت الحروب السنية - الشيعية في تلك المرحلة تخاض بأقنعة، إما خلف أقنعة العروبة وإما خلف أقنعة الدولة. خيضت معارك ضارية في هذا الشأن. هل ننسى حروب نظام الأسد في لبنان؟ هل ننسى حروب المخيمات وحصارها (المفارقة أن "حركة أمل" تحتفل الآن بذكرى تغييب السيد موسى الصدر بشعارات "القدس معراجنا"). شهد لبنان موجة من التهجير والذبح والتدمير لا تختلف عن سلوكيات "داعش" المشينة والمقززة. ربما كان ينقص عمليات القتل، وجود كاميرا و"يوتيوب".
لم تأتِ "الداعشية" من السماء. بعض الذين يتفلسفون الآن حولها، ينسون أو يتناسون سواطيرهم وسيوفهم ورصاصهم. لا أحد يقدر على محو الذاكرة، لا المالكي ولا صدام حسين ولا بشار الأسد، ولا أحد يمكنه أن يزيل بلقيس الراوي من ضحايا تفجير السفارة العراقية في بيروت، كما لا يمكن كتب التاريخ أن تتجاوز إجرام صدام حسين وحافظ الأسد.
في كل الأحوال، "الداعشية" مصيبتنا جميعاً. فلكل جماعة "داعشها" المريب والمخيف، ولكل طائفة أفعالها المشينة والفتاكة. هل ننسى حروب الجبل والكرنتينا وتل الزعتر والدامور وطرابلس؟ ربما الجمهور الشعبوي ينسى بحكم التحولات، لكن الكلمات تحفظ الذاكرة. كانت "الداعشية" حاضرة بقوة منذ عقود في الحرب اللبنانية وسوريا والعراق وإيران، لكننا لم نكن ننتبه إليها. ربما لم نكن معنيين بما يجري، كأن الاجرام من البديهيات عندنا.
في منتصف الثمانينات حصلت موجة من الاغتيالات الوحشية وعمليات خطف الرهائن الغربيين. ففي العام 1986، لقِي الفرنسي ميشال سورا حتفه في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد عام على اختطافه وعلى معاينته للبربرية التي ناقشها وحلّلها في كتاباته عن "الدولة البربرية". كتب الراحل سمير قصير عن سورا قائلاً "لم يكن يستحق ان يعيش حراً في المدينة التي أحب لأنه صادق العرب ودافع عن فلسطين وترجم كنفاني وتواطأ مع فكر الاسلاميين. كان يستحق أن يعيش حراً بمجرد كونه انساناً". لم يكن سورا الا واحداً من عشرات الأجانب الذي خطفوا أو قتلوا في بيروت، أو كان "الحرس الثوري" الإيراني يبادلهم بالأسلحة الغربية.
ثم جاءت موجة اغتيالات المثقفين والإعلاميين والمقاومين الشيوعيين من حسين مروة الى مهدي عامل وسهيل طويلة وخليل نعوس ونور طوقان وميشال واكد. هذه المرحلة لم تدرس جيداً في الكتب الثقافية، وبقيت شبه مهمشة. لكن في الواقع لا يمكن فصلها عن السلوك "الداعشي". كان الهدف الأساسي لقتل الشيوعيين، إلغاء دورهم المقاوم في الجنوب. انتهت الحرب الأهلية وحضرت "الداعشية" السياسية التي نفّذها النظام السوري وأعوانه وكان من ثمارها تهميش الدور المسيحي. ومع عام 2005 اجتاحت لبنان موجة جديدة من الاغتيالات طاولت السياديين. حتى اغتيالات هذه المرحلة لا يمكن فصلها عن صراع النفوذ بين السنّة والشيعة.
ما يحصل الآن في المشرق العربي، هو لهيب ما بدأ في بداية الثمانينات وما قبل الثمانينات، من العراق إلى سوريا وحتى فلسطين وليبيا. هو لهيب صواريخ وسكاكين ورؤوس مقطعة. في الجوهر، هو تراكم أزمات وعقول متحجرة تصنّم التاريخ والماضي. المعضلة أن كل شيء ينحو لأن يتحول رماداً، من العراق الى لبنان وسوريا وفلسطين، وجوهر المشكلة تنامي المارد المذهبي.
مَن قتل بلقيس الراوي هو الذي قتلنا ويقتلنا جميعاً. وهو القاتل نفسه بألوان وأطياف وتبريرات مختلفة. القاتل نفسه الذي كلما تقدمنا الى الأمام زاد توحشاً.
اللافت أنه لمجرد نشر خبر احتمال قيام عائلة بلقيس بدعوى ضد المالكي، اعتبر بعض الاعلام الممانع أن بلقيس "وسيلة سعودية جديدة للحرب على المقاومة". هل علمتم وذقتم؟
&





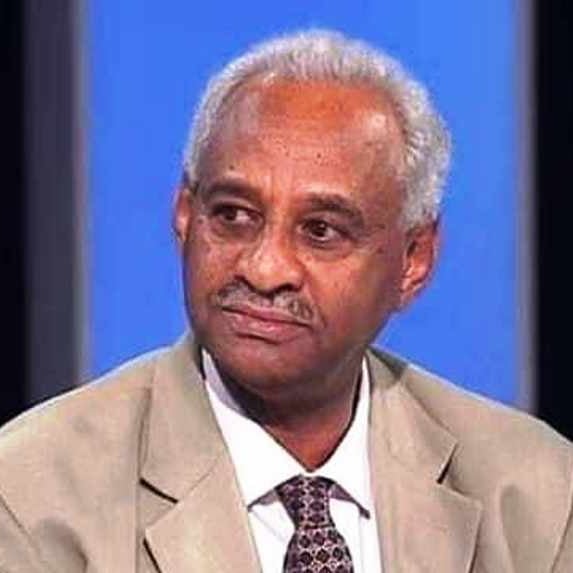















التعليقات